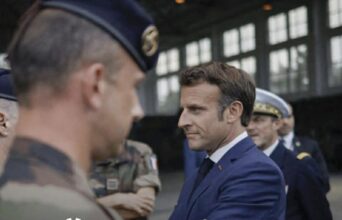النيوليبرالية والمنظمات الدولية

كتب محمد إسماعيل:
أفتتح بهذا المقال عامي الجديد في سلسلة الكتابة عن النيوليبرالية من بوابة شديدة الحساسية في السودان: المنظمات الدولية والـ NGOs. وهو موضوع طُرح عليّ كثيراً لأتناوله بوضوح، لكن من دون السقوط في خطاب التخوين السهل أو في نظرية المؤامرة الجاهزة. سأحاول أن أقدّم قراءة نقدية وتحليلية لدور المنظمات في السودان، لا باعتبارها “شرّاً مطلقاً”، ولا باعتبارها “مخلّصاً”، بل باعتبارها جزءاً من بنية سياسية واقتصادية أوسع، كثيراً ما تُعيد إنتاج الدولة الضعيفة وتطبع فكرة إدارة الأزمة بدل حلّها جذرياً.
أول ما يجب قوله بوضوح: المنظمات الدولية ليست كتلة واحدة. داخلها فروق كبيرة، وفيها آلاف العاملين الذين يشتغلون بإخلاص وسط ظروف خطرة. وهي في السودان—خصوصاً في الحرب—أنقذت أرواحاً فعلاً، وساهمت في الغذاء والدواء والحماية، وساندت شبكات التضامن المحلي، ووفرت موارد للتكايا والمبادرات. هذا الجانب الإيجابي لا يمكن إنكاره ولا يجب تهميشه، لأن الناس في الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة لا يناقشون المنظمات كمفهوم، بل يواجهون الجوع والمرض والنزوح كواقع.
لكن الاعتراف بهذا الدور الإنساني لا يمنع أن نسأل السؤال الأصعب: ماذا تفعل المنظمات على المستوى البنيوي؟ هل تساعد على بناء دولة قادرة، أم تساعد—حتى دون قصد—على تكريس واقع الدولة العاجزة؟ هنا تبدأ المشكلة النيوليبرالية.
في منطق النيوليبرالية، الدولة يجب أن تنسحب من تقديم الخدمات، أو على الأقل أن تتحول من “مزوّد” إلى “منسّق” فقط. وفي الدول الهشة، يحدث شيء أكثر قسوة: الدولة لا تنسحب لأنها اختارت ذلك بحرية، بل لأنها انهارت أو أُضعفت أو اُختطفت. عندها، تدخل المنظمات لملء الفجوة. هذا يبدو إنسانياً، لكنه يحمل مفارقة خطيرة: كلما توسع دور المنظمات في تقديم الخدمات الأساسية، كلما فقدت الدولة شرعيتها ووظيفتها في أعين الناس، وكلما صار المجتمع يعتمد على قنوات خارج الدولة. وهكذا تصبح الأزمة قابلة للإدارة، لا قابلة للحل.
في السودان، نرى هذا بوضوح منذ عقود، لكنه يتضاعف في زمن الحرب. حين تصبح الإغاثة هي القناة الأساسية لبقاء الملايين، يتحول المجتمع إلى “ملف إنساني” أكثر من كونه مجتمعاً سياسياً. تضعف فكرة المواطنة، وتُستبدل بفكرة “المستفيد”. ويصبح السؤال: “كيف نغطي الاحتياج؟” أهم من السؤال: “لماذا تكررت الكارثة؟ ومن المسؤول عن بنية الاقتصاد التي أوصلتنا هنا؟”. المنظمات بحكم تفويضها تعمل في مساحة الاحتياج، لكنها في الوقت نفسه—بوعي أو بدونه—تساهم في نزع السياسة عن الأزمة.
أحد أهم مظاهر ذلك هو ما يمكن تسميته “تطبيع إدارة الأزمة”. في العمل الإنساني، يتم تقسيم المجتمع إلى قطاعات: غذاء، صحة، حماية، تعليم، مياه. تُحلّ المشكلة كأنها مجموعة احتياجات تقنية منفصلة. بينما في واقع السودان، الأزمة ليست “نقص غذاء” فقط، بل نتيجة اقتصاد منهوب، ودولة ضعيفة، وحرب، واحتكار موارد، وانهيار عقد اجتماعي. حين تُدار المأساة كقطاعات، تُفقد القدرة على رؤيتها كمنظومة. وحين تُدار كمنظومة تقنية، يصبح الحل سياسيّاً أقل إلحاحاً. لا لأن العاملين لا يريدون الحل، بل لأن البنية التمويلية ذاتها لا تموّل السياسة، بل تموّل الاستجابة.
ثم تأتي قضية التمويل والمانحين، وهي نقطة مركزية. كثير من المنظمات—مهما كانت نواياها—تتحرك ضمن أولويات المانحين. والمانحون لديهم منطقهم: يريدون نتائج سريعة قابلة للقياس، مشاريع محددة، مؤشرات، تقارير، و”قصص نجاح”. هذا المنطق ينتج نوعاً من التدخلات القصيرة التي تُسعف المجتمع لكنها لا تبني مؤسسات. في السودان، تجد مشاريع تدريب، ووعي، ودعم سبل عيش مؤقت، بينما تبقى أسئلة الإنتاج الحقيقي، والبنية الضريبية، والموارد السيادية، خارج نطاق التمويل أو محرّمة سياسياً. وهكذا تتحول التنمية إلى “مشروع”، لا إلى مسار وطني.
وهنا يظهر أثر آخر: سوق الوظائف الإنسانية. في بلد مثل السودان، تتوسع المنظمات وتصبح واحدة من أكبر جهات التوظيف للمتعلمين والناشطين. هذا يوفر فرصاً، لكنه أيضاً يسحب طاقات المجتمع من بناء مؤسسات محلية مستقلة نحو وظائف مرتبطة بالتمويل الخارجي، وبالدورات الزمنية للمشاريع. ومع الزمن، تتشكل نخبة من “مديري المشاريع” و”الخبراء” الذين يتقنون لغة المانحين أكثر مما يتقنون لغة السياسة الوطنية. لا يُلام الأفراد على ذلك؛ إنه منطق الحقل. لكن نتيجته هي أن جزءاً من الطاقة المدنية يتحول من فعل سياسي طويل النفس إلى إدارة مشروع قصير النفس.
جانب آخر حساس يتعلق بالعلاقة مع الدولة نفسها. كثير من المنظمات تضطر للتعامل مع سلطات الأمر الواقع، أو مع بيروقراطيات ضعيفة، لضمان الوصول. هذا مفهوم عملياً، لكنه قد يؤدي إلى نتائج خطرة: تطبيع وجود سلطات غير شرعية، أو تقوية شبكات محلية مستفيدة من الإغاثة، أو خلق اقتصاد ظل حول التصاريح والعمولات والوساطة. في السودان، مع الانهيار الحالي، تصبح هذه المخاطر أكبر: الإغاثة نفسها يمكن أن تتحول إلى مورد تنازع، وإلى قناة تمويل غير مباشر لقوى مسلحة أو شبكات فساد، حتى لو كانت نية المنظمات عكس ذلك.
ومع ذلك، سيكون خطأ كبيراً أن نكتب هذا المقال كإدانة مطلقة. للمنظمات أدوار إيجابية حقيقية، خاصة في السودان اليوم. من ذلك أنها توفر الحد الأدنى للحياة في لحظة انهيار، وتدعم بعض الخدمات التي تمنع الكارثة من أن تكون أوسع، وتساعد في توثيق الانتهاكات، وتبني قدرات بعض الفاعلين المحليين، وتفتح مساحات حماية للفئات الأكثر هشاشة، وتُبقي السودان حاضراً في الضمير الدولي حين تحاول الحرب أن تبتلعه في الصمت.
لكن الإشكال هو أن هذه الأدوار الإيجابية قد تتحول—إذا لم تُفكر سياسياً—إلى جزء من إعادة إنتاج الأزمة. السودان لا يحتاج فقط إلى طعام اليوم، بل إلى اقتصاد لا يُجوعه غداً. ولا يحتاج فقط إلى مستشفى طوارئ، بل إلى نظام صحة عام. ولا يحتاج فقط إلى حماية مؤقتة، بل إلى دولة قانون. والمنظمات—بحكم طبيعتها—لا تستطيع وحدها أن تصنع هذا التحول، بل قد تعيق ظهوره إن أصبحت بديلاً دائماً للدولة.
لذلك، النقد هنا يجب أن يكون موجهاً إلى النظام الذي يجعل المنظمات بديلاً مستمراً، لا إلى العاملين فيها كأفراد. النقد يجب أن يطال منطق التمويل الذي يحب إدارة الأزمة أكثر من حلّها، ويحب المؤشرات أكثر من التحول البنيوي، ويحب الاستقرار الشكلي أكثر من العدالة. ويجب أن يطال أيضاً النخبة المحلية التي تستفيد من هذا النظام، وتعيد إنتاجه، وتقدم نفسها بوصفها “محايدة” بينما هي جزء من هندسة الواقع.
هذا المقال ليس دعوة لطرد المنظمات ولا لمعاداة العمل الإنساني. هو دعوة لرفع السقف: أن نسأل كيف نجعل الإغاثة جسراً لبناء دولة، لا بديلاً عنها. كيف نجعل التمويل يدعم المؤسسات العامة، لا فقط المشاريع. كيف نربط الاستجابة الإنسانية بطرح اقتصادي وسياسي يعالج الجذور، لا الأعراض. هذه الأسئلة صعبة، لكنها ضرورية إذا أردنا أن نفهم النيوليبرالية في السودان: فهي لا تعمل فقط عبر الحكومة أو السوق، بل تعمل أيضاً عبر الطريقة التي تُدار بها الأزمة نفسها.
في المقالات القادمة يمكن أن نذهب أعمق: كيف تحوّل النيوليبرالية مفهوم “المجتمع المدني” نفسه؟ وكيف تتقاطع الإغاثة مع اقتصاد الحرب؟ وما حدود الممكن في زمن الانهيار؟